من الكتب اللافتة للنظر، الصادرة مؤخرا في العاصمة الفرنسية،
كتاب الباحث أرنو إسكيري «ممنوع من المشاهدة. الجنس والعنف وحرية التعبير في السينما» (منشورات فايار، باريس، 246 صفحة)،
الذي يتتبع فيه، وبدقة، أساليب الرقابة التي طبقت في «عاصمة النور»،
منذ أيام الثورة الفرنسية، وحتى بعد ظهور السينما في تسعينيات القرن التاسع عشر.
ويرد المؤلف ذلك، إلى «تطور وسائل وأسباب التحكم التي ستتبع بعضها البعض على مدى عقود في محاولة للحفاظ على إنتاج الفيلم الذي تمت دعوة المشاهد إليه مقيداً».
بدأ كل شيء في 11 كانون الثاني من العام 1909 بتعميم وُجّه إلى المحافظين،
يأمرهم بحظر أي فيلم «يصور عمليات الإعدام»،
وقد مُنح رؤساء البلديات كل الصلاحيات في هذا الشأن.
استمر الأمر على هذا المنوال لغاية 19 نيسان من العام 1913 حين صدر تعميم جديد أضيف إليه سبب آخر للحظر،
يتمثل في منع «كل المشاهد ذات الطبيعة الفاضحة وغير الأخلاقية».
«لقد ازداد الأمر سوءا: لقد بدأت الرقابة «الحقيقية»،
حيث تمكنت الكنيسة، بدءا من ذلك الحين «من وضع قدمها في الباب»!
لكن هذا لم يكن كل شيء. إذ خلال الحرب العالمية الأولى، أعلنت دائرة الشرطة عن بدء العمل بضرورة الحصول على تأشيرة تجيز عرض أي فيلم (كانون الأول 1915).
وفي أعقاب ذلك، شكل وزير الداخلية الفرنسية لجنة لفحص الأفلام (مشاهدتها)، قبل عرضها،
لتبدأ آلة التحكم في العمل،
وقد كلف بتشكيل هذه اللجنة بدءا من العام 1919 وزير التربية والفنون الجميلة، وهدفها «أعمال التطهير والتنقية» وفقا للمبادئ التالية:
– تجنب ما قد يضر بقوة أجنبية.
– عدم السماح بتقديم لوحات ثورية وخاصة فيما يتعلق بالبلشفية.
– عدم السماح بعرض مشاهد الإضرابات، كما مشاهد التناقضات الواضحة بين الغنى والفقر إذ قد يتسبب ذلك في حركة ما داخل دور السينما.
– عدم مسامحة التسيّب.
– محاولة تخفيف حدة مشاهد العنف وتقليل عدد مشاهد الجرائم، على الأقل على الشاشة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن اهتمامات السلطة الفرنسية في هذه المرحلة كانت في أساسها اهتمامات سياسية،
إذ هذا «التسيب» لم يحدث إلا في نهاية الأمر؛ «فالمستقبل لها»!
يقول إسكيري: «بمجرد فرض رقابة الدولة، أنشأت الكنيسة الكاثوليكية، وهي مؤسسة كانت لا تزال قوية في فرنسا في ذلك الوقت، رقابتها الخاصة على الأفلام،
ففي العام 1927 أسست «لجنة الأفلام الكاثوليكية».
وقد اقترحت مجلة «اختر»، وهي صحيفة كاثوليكية، منذ عددها الأول،
أن تصنف الأفلام وفق «التصنيف الأخلاقي»؛
بعد ذلك،وبتوجيهات من البابا، نقلها الكاردينال باتشيلي،
تم تحويل اللجنة إلى «المركز الكاثوليكي للسينما والراديو» (CCR) الذي شجع الشركات المنتجة الكبرى على إجراء عمليات قص للأفلام إذا كانت لا ترغب في خسارة ما بين مليون ومليون ونصف من الايرادات وفق حسابات الشركة. وبالتالي، فإن «رقابة الكنيسة لم تكن فقط عملية قمع لمنع وصول الأفلام، من خلال توصياتها، إلى المؤمنين، بل كانت أيضًا عملية قمع لمحتوى الأفلام»، كما يشير أرنو إسكيري.
شهدت الحرب العالمية الثانية تنافساً بين مختلف أشكال الرقابة، بين المنطقة المحتلة والمنطقة الحرة، مع العلم أن منطق رقابة الكنيسة لا يمكن أن يتطابق دائماً مع منطق رقابة الدولة.
فــ «المركز الكاثوليكي…» كان يرغب في توسيع نفوذه من خلال الإعلان أن «الرغبات التي عبر عنها المارشال تتوافق مع رغباتنا الخاصة»
-هذا بالنسبة للمنطقة الحرة – أما في المناطق المحتلة،
فنجد أن الألمان أرادوا حظر أي فيلم يشتبه في أنه «معادٍ لألمانيا»،
فلم يسمحوا للسلطات الفرنسية بمنع الأفلام المرخصة من قبل الرقابة الألمانية.
ومن بين «النكات»، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الأفلام المتهمة بالتحريض على كراهية ألمانيا ممنوعة بشكل واضح، فإن «جميع الأفلام التي قامت ببطولتها ميشيل مورغان» ممنوعة أيضاً! كما كل تلك التي كتب سيناريوهاتها الشاعر جاك بريفير، ولأسباب غير مفهومة.
استمر «سباق الفئران هذا» بين الرقباء المتنافسين حتى نهاية الحرب،
لكن النظام الذي تم وضعه قبل الأعمال العدائية سيتم تعديله على الهامش فقط،
وسيكون من الضروري انتظار العقد الأخير من القرن العشرين، وبعد أيار 68،
لكي تتحرك الأمور على محمل الجد.
قبل ذلك، وبينما كان وزير الإعلام يتولى دور الرقيب،
تم «تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد فيلم المخرج جاك ريفيت «سوزان سيمونين، راهبة ديدرو».
من الواضح أن الكنيسة الكاثوليكية هي المسؤولة عن ذلك،
إذ كان أحد أعضاء لجنة المراقبة الأب بيهان.
قُدّم سيناريو الفيلم في أيار من العام 1962، إلى اللجنة التي أصدرت رأيا غير مؤيد؛
بعد إعادة الكتابة، بدأ التصوير العام 1965،
لكن الأب بيهان طلب تدخل أعلى شخصية في الكنيسة الفرنسية،
المونسنيور فيلتين، الذي طلب من الوزير إيقاف تصوير فيلم يخاطر بـــ «الإساءة إلى المؤسسة الدينية كما على الكنيسة»؛
وبعد أن طُلب رأيه، أصدر الجنرال ديغول أوامره بمعارضته صنع الفيلم.
ومع ذلك، سمحت اللجنة بإصدار الفيلم في 29 آذار 1966، مع حظر على من هم دون سن الثامنة عشرة مشاهدته.
وبما أنه كان ضد هذا الرأي، قام وزير الإعلام، إيفون بورجيه، بحظر الفيلم تماما.
لكن وزير الثقافة، أندريه مالرو، قرر دعم عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي العام 1966.
تطلب أمر إلغاء الحظر من قبل المحكمة الإدارية، انتخابات تشريعية جديدة وتغيير الحكومة حتى يتم توزيع «سوزان سيمونين» في العام 1967.
أي استغرق الأمر خمس سنوات حتى يختبر الجمهور أخيرا أهوال المتدينين!
في أي حال لم تكن أحداث أيار بعيدة…
في عام 1969، في ظل رئاسة جورج بومبيدو، ألغيت وزارة الإعلام، وكلف وزير الشؤون الثقافية بإدارة اللجنة. وصل اليسار إلى السلطة،
وكان جاك لانغ يخطط لإلغاء لجنة الرقابة.
عارضت وزارة الداخلية الأمر، إلا أن لانغ أعلن لرئيس اللجنة: «اقترح عليّ حظرا تاما إن أردت، فأنا لن أوقع عليها أبدا». وهذا ما حدث بالفعل.
يأتي كتاب إسكيري مليئا بالوثائق، ولنتابع من خلالها وبالتفصيل العديد من حالات الأفلام التي حركت عقول الناس بمرور الوقت. يحلل المؤلف كيف يفسر المفوضون الأفلام، ووفقا لأي معايير. وإذا لم يكن هناك، في الوقت الحاضر، المزيد من المنع الكامل، إلا أنه لا تزال هناك بعض المحظورات التي تمت صياغتها فيما يتعلق بالقاصرين، ويرجع ذلك أساسا إلى صور لأفعال جنسية أو عنف كبير.
لكتابة مؤلفه هذا، تمكن إسكيري من مطالعة أكثر من أربعين ملفا سينمائيا، في أرشيف «المركز الوطني للسينما»، بدءا من سوزان سيمونين (اخراج جاك ريفيت، 1966) إلى «خمسون تدرجا واضحا» (جيمس فولي، 2018) مرورا بــ «كين بارك» (لاري كلارك 2003)
و«حب» (غاسبار نويه، 2015)… لكن المفاجأة الفعلية، برأيي،
أن الكاتب لم يذكر أي شيء عن تحفة ناغيزا أوشيما السينمائية «امبراطورية الحواس» (1976)
والتي تحدت كل أنواع الرقابة.
الفيلم أخرج في اليابان، ولكنه أنتج في فرنسا من قبل أناتول دومان،
ويتناول القصة الحقيقية لـ أبيه سادا، التي وردت في صفحة «أخبار متفرقة» العام 1936.
يومها اعتبر «خبر» إجرامي اندلع في طوكيو؛
إلا أنني أستعيد ما قاله ميشيما عن فيلمه، بأنه فعل «حب مجنون»،
وهو تتويج حقيقي لمغامرة إيروسية تتحرك «نحو شكل من أشكال التقديس».
ولا أيضا عن فيلم «التانغو الأخير في باريس» (لبرلوتوتشي، 1972) حيث لم يتقبل كثيرون أحد مشاهد الفيلم الجنسية وكادت الرقابة تطيح به وتمنعه.
في أي حال،
لن أقوم هنا بعرض محتوى هذين الفيلمين، فقط أقتبس ما قاله ذات يوم الفيلسوف والكاتب الفرنسي جورج باتاي (وبالمناسبة أوقفت الرقابة روايته «أمي» لسنوات طويلة): «الإيروسية هي قبول الحب حتى في الموت»،
عبارة جذابة يبدو أنها كتبت خصيصا لهذه المناسبة.
مع العلم أنها المرة الأولى، في فيلم أوشيما،
وأتحدث هنا عن فيلم عادي – لا عن فيلم اباحي – يتم كسر جميع المحرمات.
فالممثلون (وليس بدلاؤهم) هم من يمارسون الحب حقا أمام الكاميرا من دون قيود،
لذا تمكن أوشيما من التعبير عن كل تأجج العلاقات المثيرة التي تنحو بفيلمه تجاه المقدس،
الذي لم تستطع أي سلعة إباحية تحقيقه.
فما اعتبر «فاحشة» في الفيلم، لم يكن سوى افساح المجال للمتعالي ليضع المتفرج في حضور بيان لصالح الحب المجنون،
لأن الإفراط في التمثيل المقدم له يفتح عينيه على مساحة خالية من الحدود، فضاء الحرية الشعرية.
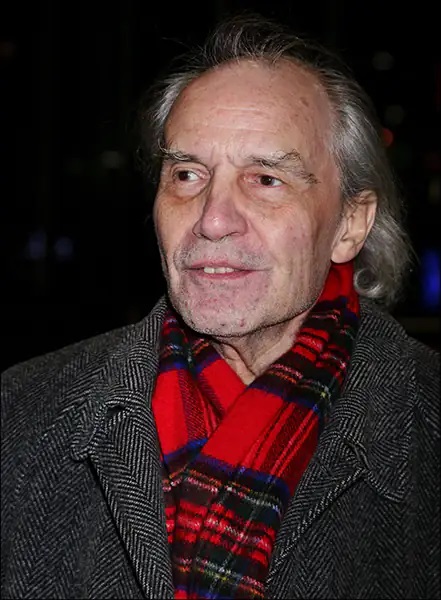
في بداية كتابه،
يستحضر المؤلف المرسوم المتعلق بالعروض، العائد إلى العام 1791.
كان يومها روبسبير، حاضرا مناقشة المشروع،
فاعترض على المادة السادسة من هذا المرسوم: «لا شيء يجب أن يؤثر على حرية المسارح، ومع ذلك فإن المادة السادسة، حطمت ذلك. … الرأي العام هو الحكم الوحيد على ما يتفق مع الخير. لذلك لا أريد حكما غامضا يمنح موظف البلدية الحق في تبني أو رفض أي شيء قد يرضيه أو يضايقه؛ وبالتالي، يفضل المرء المصالح الخاصة وليس الآداب العامة. أختتم بأننا نرجئ المشروع بأكمله بدلاً من اعتماد المادة السادسة».
صحيح أن حرية التعبير في فرنسا، الدولة التي تقدم نفسها على أنها ديمقراطية، تتوسع باستمرار.
ومع ذلك، لو ذهبنا إلى كواليس «الرقابة» في السينما كما تمارس اليوم،
فإن ما يُدعى القارئ لاكتشافه هو لماذا لا يتم الفوز بحرية التعبير قط.






